مثل الحياة الدنيا
﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ
مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُقْتَدِرًا﴾(الكهف:45).
هذا مثل آخر للحياة الدنيا ضربه الله تعالى لعباده، شبه فيه مثلها، في
نضارته وبهائه، وجماله وحلاوته، بنبات الأرض، يكون أخضر وارفًا زاهيًا
نضرًا، ثم بعد ذلك، يصبح هشيمًا جافًا، تحمله الرياح، لخفته ولطافته،
وتفرقه في كل جهة من جهات هبوبها.. كذلك الحياة الدنيا، كنبات هذه الأرض..
وهكذا الأمور بعد زوالها؛ كأنها لم تكن!
ومناسبة هذا المثل لما قبله أن الله تعالى، لما ضرب في الآيات السابقة
لهذه الآية الكريمة مثل الكافر والمؤمن، وبين فيه حالهما، وما آل إليه ما
افتخر به الكافر من الهلاك، أتبعه سبحانه وتعالى بضرب هذا المثل.
فقوله تعالى:﴿ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ مشبه، وهو معنى معقول موجود
في الذهن، وقوله تعالى:﴿ مَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾
مُشبَّه به، وهو معنى محسوس موجود خارج الذهن، وقد اجتمع المعنيان في
الزينة والبهجة، ثم الهلاك والزوال.
هذه هي الحياة الدنيا، التي اغترَّ بها المغترون، وتهالك عليها
المتهالكون. وهذا هو مَثَلها. ومثلها- على ما تقدم في المثل السابق- هو
متاعها المماثل لها في تمام أحوالها وصفاتها. ولإفادة هذا المعنى جيء-
هنا- بلفظ المثل في طرف المشبه، دون المشبه به.
وقيل: إن هذا المثل مختصر من المثل السابق؛ وهو قوله تعالى:
﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا
أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ
تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾( يونس: 24 ) (1)
والغرض منهما: تنبيهُ العباد إلى أن كل ما في الحياة الدنيا من نعيم-
كثُرَ، أو قلَّ- فمصيره إلى فَناء وزوال؛ كما أن نبات الأرض مآله إلى هلاك
وبوار. وفي ضمن ذلك التحذيرُ من الاغترار بنعيم الدنيا، وزينتها؛ لأنه
متاع ٌ فانٍ، وكلُّ فانٍ حقير، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى محذرًا:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ
﴾(فاطر:5).
وقد بينت في المثل السابق سر الإعجاز في تقديم الماء على النبات في قوله تعالى:
﴿ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾
إذ من حق كاف التشبيه أن تدخل على المشبه به، وهو النبات، لا الماء، كما
بينت سر الإعجاز في مجيء هذه العبارة الموجزة، على هذا النظم البديع، الذي
جعل نبات الأرض هو الذي يختلط بالماء، فينمو ويحسُن، ويعلوه الزهر والنور
والنضرة.. وذكرت أن المراد بنبات الأرض هو حَبُّها، الذي بُذِر فيها قبل
أن يكون نباتًا، وأن معنى الباء في قوله تعالى:﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ ﴾
الإلصاق والاختلاط.
وعلى الرَّغم من هذا التطابق، الذي نشاهده بين المَثلين فإن ثمَّةَ فروق
ظاهرة بينهما، لا بدَّ من الإشارة إليها، والكشف عن أسرار الإعجاز فيها:
1- وأول هذه الفروق: أن ما ذكِر في المثل الأول من مراحل حياة النبات، قد
طُويَ أكثره في هذا المثل، ولم يذكَر من ذلك سوى: اختلاط النبات بالماء
المنزل من السماء، ثم انتهاؤه إلى أن أصبح هشيمًا، تذروه الرياح.
وسبب ذلك أن الله تعالى، لما أراد أن يزهِّد عباده في متاع الحياة الدنيا
ونعيمها، ويرغبَّهم في الآخرة، أخبرهم أن بغيهم على أنفسهم باطل، لا بقاء
له، وأن مرجعهم في النهاية إليه سبحانه، فينبئهم بما كانوا يعملون في هذه
الحياة الدنيا الفانية؛ وذلك قوله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(يونس:23)
وفي ذلك من التحذير، والوعيد بالعذاب ما فيه! ثم أتبع سبحانه وتعالى ذلك التحذير والوعيد بضرب المثل لهم، فقال جلَّ شأنه:
﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا
أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ
تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾(يونس:24)
فالمقام- في هذا المثل - مقام تبيين وتفصيل؛ ولهذا اهتمَّ سبحانه وتعالى
فيه بشرح الخطوات، التي تخطوها الحياة الدنيا في طريق النهاية، فتابع
مراحل نزول الماء من السماء، ولم يدع حالة من حالاته إلا نصَّ عليها..
فالماء ينزل من السماء، فيختلط به نبات الأرض، ويظهر أثر هذا الاختلاط
فيما يكتسبه من حسن واخضرار وازدهار، حتى إذا استكملت به الأرض حسنها،
ولبست بألوانه المتنوعة، وأشكاله المختلفة أبهى حُلَلِها، وأجمل حِليِّها،
واطمأنَّ إليه أهلها؛ لسلامته من الآفات، وبلوغه مرحلة القطاف والحصاد،
أتاه أمر الله تعالى بغتة، فجعله حصيدًا؛ كأن لم يَغنَ بالأمس.
ولما أراد الله تعالى أن يصور سرعة انقلاب الحياة الدنيا على أصحابها،
وإدبارها عنهم بعد إقبالها عليهم، ضرب لهم المثل، الذي يصور فناء الدنيا،
وسرعة تقضيها، بما يشاهدونه في حياتهم من سرعة ذبول النبات وجفافه، ثم
هلاكه بعد زهائه واخضراره، فقال سبحانه:
﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ
مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾
(الكهف:45).
فكان المقام- هنا- مقام تصوير لحال الدنيا في سرعة إقبالها، وإدبارها
اقتضاه سياق الآيات، وهو أشبه بحال الصاحب الكافر، الذي أخبر الله تعالى
عنه بقوله:
﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ
تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ
رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
﴾(الكهف:35-36)
فهذا الكافر المعجَب بما أوتي من نعيم الدنيا، المفتخِر به، يقسِم لصاحبه،
إن رُدَّ إلى ربه- على سبيل الفرض والتقدير- ليَجدَنًّ في الآخرة خيرًا من
جنته.. وهكذا أصابه الغرور في مقتله، فأصبح، لمَّا أحيط بثمره..
﴿ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا
﴾(الكهف:42).
هذا الانقلاب السريع، من حال إلى حال بهذه السرعة، لا يناسبه إلا بناءُ
التشبيه- في هذا المثل، الذي أعقبه- على طيِّ مراحل نمو النبات وزهائه
واخضراره؛ ولهذا قال سبحانه:
﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾
فأتى بالفاء العاطفة، التي تشعِر بهلاك النبات وانتهائه إلى تلك الصفة؛ وهي كونه هشيمًا، تذروه الرياح.
2- وثاني الفروق بين المثلين: أن الله تعالى قال في هذا المثل:
﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾
فقيَّد الخبر بـ﴿ أَصْبَحَ ﴾؛ ليدلَّ به على سرعة هلاك النبات، وتحوله من
حالة جيدة، كان عليها في المساء إلى حالة سيئة، أصبح عليها القوم في
الصباح،﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾(الصافات: 177).
وقال تعالى هنا:﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا ﴾، فعبَّر عن هلاك النبات بالهشيم؛
لأنه من الهَشْم. والهَشْمُ هو كسْرُ الشيء الرَّخْوِ وتفتيته، ويختصُّ
بما هو رَطبٌ، ثم يصير يابسًا؛ كالنبات، والخبز، وغيرهما. والعرب تسمِّي
كل شيء كان رطبًا، فيبس: هشيمًا. والهشيم أيضًا هو الرجل الضعيف.
وأصل الهشيم: النبت إذا جفًّ ويبس، فأذرته الريح؛ وذلك للطفه وخفته، وتلك
هي حال الذرِّ؛ ولهذا قال سبحانه:﴿ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾، فعبَّر عن هذا
المعنى بـ﴿ تَذْرُوهُ ﴾، لما في ذرا، يذرو من معنى الارتفاع، والسرعة.
يقال: ذرا فلان يذرو: ارتفع، ومرَّ مرًّا سريعًا، ومنه سُمِّيت الرياح
بالذاريات. قال تعالى:
﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴾(الذاريات : 1)
وإنما سميت بذلك؛ لأنها تحمل التراب، أو الهشيم عاليًا، وتفرقه بسرعة في كل جهة؛ بحيث يستحيل إعادته كما كان.
وفي حديث علي كرَّم الله وجهه:” يذرو الرواية ذَرْوَ الريحِ الهشيمَ
“. أي: يسرد الرواية؛ كما تنسف الريح هشيم النبت.. وقال الخليل
معلِّلاً لتسمية بني آدم ذرية:” إنما سُمُّوا: ذريَّة؛ لأن الله
تعالى ذراها على الأرض؛ كما ذرأ الزارع البَذْرَ “.
أما في المثل السابق فقال تعالى:
﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴾
فقيَّد الخبر بقوله:﴿ جَعَلْنَاهَا ﴾؛ لأن جعل لفظ عام في الأفعال كلها؛
فهو أعمُّ من فعل، و صنع، وسائر أخواتها. ومن تصرُّفه في الاستعمال اللغوي
أنه يجري مَجرى
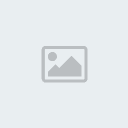
أوجد )، في تصيير الشيء على حالة، دون حالة، كما هنا، وكما في قوله تعالى:
﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ
الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾(النحل:81)
وعبَّر سبحانه وتعالى عن هلاك النبات وزواله بالحصيد؛ لأنه من الحصد.
والحصد هو قطع الزرع . والحصيد: فعيل من الحصاد؛ وهو قطع الزرع في
إبَّانه، وقد أفاد- هنا- قطع النبات واستئصاله في غير إبَّانه على سبيل
الإفساد. ومنه استعير: حصدَهم السيفُ. وقد جعل الله تعالى هلاك المهلكين
من الأمم الطاغية حصادًا لهم، فقال:﴿ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ
﴾(هود:100).
3- وثالث الفروق بين المثلين أن هذا المثل ختم بقوله تعالى:
﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾
فعبَّر سبحانه عن مطلق قدرته، وكمالها بأنه مقتدرٌ على كل شيء من الأشياء،
التي من جملتها الإنشاء، والإفناء، وإفقار الغنيِّ المتعالِي، وإغناء
الفقير المتعالَى عليه، وغير ذلك. وفي هذا ما فيه من إحلال للأمل محل
الألم في نفوس الفقراء المؤمنين، فضلاً عمَّا فيه من تهديد لأولئك
المتعالين المتكبرين!
أما المثل السابق فقد ختم بقوله تعالى:
﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
لأن السِّيَاق سياق تفصيل، ورسم لخطوات الحياة الدنيا، التي تخطوها في
طريق النهاية؛ بحيث لا يدع مجالا للتشكُّك في صحة ما فُصِّل وصوابه، فلا
يعدم من كانت له القدرة على التفكُّر والتدبُّر من الانتفاع بهذا التفصيل،
فضلاً عمَّا في هذا الختام من تقريع لأولئك الذين لا يتفكرون بآيات الله
تعالى، ولا يتدبرون، فينتفعون!
الأستاذ: محمد إسماعيل عتوك
الباحث
في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن
